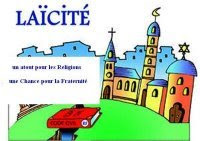الحريم في الجامعة
يقول الخبر الذي نشره موقع "الأوان" بتاريخ 26 جوان 2008 وأورده سمير بوعزيز تحت عنوان: إلى الأستاذة الأصوليّة التي طردت طالبة من قاعة الامتحان لأنّ ذراعيها مكشوفان.. : " نشر أحد مواقع الانترنت (تونسنيوز) خبرا أكّده شهود عيان، ومفاده أن أستاذة جامعية بإحدى الكليات التونسية (كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل) طردت طالبة من قاعة الامتحان لأن ذراعيها مكشوفان. ولم تتمكن الطالبة من اجتياز الاختبار إلا بعد أن وجد لها أحد الأساتذة قميصا ارتدته!" هذا هو الخبر، أما ما سيرد في القصّة التالية فهو محض خيال. و كل تشابه بينه و بين الخبر المذكور هو محض صدفة، باستثناء قصّة الكفن في نهاية المقال. أقصى طموحها هو أن تكون ريحانة (شمّ و خبيّ) أو درّة مصونة مكنونة مضغوطة مخنوقة بالقطن، أو أيّ شيء آخر، جمادا كان أم نباتا، سوى إنسانة. قيل لها تخمّري فامتثلت، ثم جاء أمر القفّاز، فالجوارب السّميكة، فالحذاء الرجالي، فالجلباب الفضفاض و أخيرا النّقاب. هكذا تحفظ الأشياء ثمينة السّعر تحسّبا ليوم حاجة وخوفا من ضربة عين، إذ يبدو أن آية "قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم" غير كافية لصدّ الحسد، و أنّ الأمر الموجّه للنساء بأن لا "يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" متسامح أكثر مما يقتضي منطق البيع و الشراء في الصّحاري. و تعقّب السعودية عائشة عبد العزيز الحشر في كتابها "خلف أسوار الحرملك" على الغلاة الذين يفرضون أن لا يظهر من المرأة شيء على الإطلاق، قائلة : " و الزّينة لن تظهر بمعزل عن المرأة. أي لن يظهر الخاتم مثلا في صندوق المجوهرات ملقى على قارعة الطريق، بل ستظهر معه الكفّ التي هو زينة فيها بالضرورة. و لن يظهر كحل العين في حقيبة يد المرأة كزينة في عينيها." و من فرط سخط الكاتبة السعودية على مجتمعها الذي يحرم المرأة من الشمس و الهواء، قفزت على خمسة عشرة قرنا لتسقط على عائشة، زوج الرسول، صفة المناضلة النّسوية بسبب تكذيبها لحديث : " المرأة و الحمار و الكلب (الأسود تحديدا) يقطعون الصلاة" و حجّتها في ذلك أن الرسول كان يصلّي و هي معترضة بينه و بين القبلة. و الأمر لا يكفي في الواقع لإضفاء صفة الثائرة على عائشة، فهي اكتفت بتكذيب خبر. و لم تكذّب الأخبار المحطة بقيمة المهينة للمرأة التي تعج بها كتب الحديث، و ارتضت مثلا أن تكون النساء ناقصات عقل و أكثر أهل النار. و الحقيقة أن مغامرة صاحبة الجمل في واقعة الجمل تغريني أكثر للتعسف بدوري على المفاهيم. فلو كانت عائشة في بلدها اليوم لكانت وفّرت على صديقتي السعوديّة وجيهة الحويدر مشقّة الاحتفال بيوم 8 مارس الماضي بالمغامرة بقيادة سيارتها في الطرقات الجانبية للمملكة. و قد وصلتني منها يومها رسالة هاتفية تقول : "هل شاهدتني و أنا أقود السيارة ؟" و هرعت إلى موقع "الديلي موشن" لأشاهد وجيهة. ولم يفهم جلّ من كانوا حولي معنى الرسالة ومعنى تسمّري أمام الشريط المملّ. ولعلهم سيفهمون يوم تحرّم على المرأة عندنا قيادة السيارة، أو يوم تتطوّع بعض الدّرر المكنونة من الحريم بمقاطعة القيادة. و للسيارة في ذاك البلد، الذي استوردنا منه كل معالم الحضارة المذكورة، وظيفة أخرى غير قطع الطرق، فهي تستخدم أيضا لقطع أنفاس النساء. تحكي عائشة في كتابها المذكور، أن العائلات هناك عندما يقررون الخروج إلى النزهة في البريّة، فأول ما يفكرون فيه هو عدد السيارات. ليس ليتأكدوا أنها تكفي الجميع بل ليصنعوا بها سورا حول النساء. و أوردت حكاية إحداهنّ حول الموضوع "كن في نزهة محاطات بالسيارات. و لأن عدد السيارات كثير فقد بقيت سيارة أخي ليس لها مكان في السّور. فظلّ ينظر و يتأكد من سدّ كلّ المنافذ. فقلت له: بقيت هذه الناحية يا أخي... هنا... هنا... " و أشارت بيدها إلى السماء. و لا أستغرب أن تقاطع ريحانتنا قيادة السيارة كما قاطعت من قبل الشمس و الهواء و إنسانيّتها تحت ضغط تجويق مفتيي تحريم كل بدعة، بما فيها الدّراجة الذين سمّوها بدابّة إبليس، و كذلك ملقط الشّعر الذين حرّموه لحديث "لعن الله النامصة و المتنمصة" و قالوا أنه يخص الحاجبين، في حين أن الحديث لم يحدد أي شعر هو المقصود. ويبدو أنهم لم يجدوا مكانا في جسم المرأة لتحريم نمصه لأن أحاديث أخرى تأمر بإزالة الشعر من الجسد. و برّروا اختيارهم للحاجبين بأنّ تغيير شكلها هو تغيير لخلقة الخالق. و تغاضوا عن أمر تخضيب لحية الرجل بالحناء في حديث:" إن اليهود و النصارى لا يصبغون فخالفوهم" كما تغاضوا عن حلق معظم الرجال اللحية التي دعت السنة إلى إعفائها. لكن من هي الريحانة التي تجرؤ على التذكير بتحريم يخص الرجل. فهي تباع و هو الشّاري الذي يفرض ذوقه على ما يشتريه ؟ يقول أحد الشيوخ، منصور البهوتي في ما وسّمه بالروض المريع:" و لا يلزم الزوج لزوجته دواء و أجرة طبيب إذا مرضت، لأن ذلك ليس لحاجتها الضرورية المعتادة، و كذلك يلزم ثمن طبيب و حناء و خضاب و نحوه من أراد منها تزيّنا أو قطع رائحة كريهة". أصبحت الزينة هنا، أي تغيير الخلقة، ضروريّة أكثر من الدواء، بل و حسب نفس "المفكر" فهي ضروريّة أكثر من الكفن. فهو يؤكّد في نفس الكتاب:" فإن لم يكن للميّت مال فكفنه و مؤونة تجهيزه على من تلزم نفقته، لأن ذلك يخصّه حال الحياة فكذا بعد الموت، إلاّ الزّوج لا يلزمه كفن امرأته و لو غنيّا لأن الكسوة وجبت عليه بالزّوجيّة و التمكن من الاستمتاع و قد انقطع ذلك بالموت" و ما ضرّ الشاة سلخها بعد ذبحها، أليس المهمّ هو أن يدفع الزوج ثمن كفن الحياة حتى لا تظهر من حريمه الحيّة بعد، حتى الزينة الظاهرة ؟ يقول الخبر الذي دارت وقائعه في جامعة تونسية، في شهر ماي 2008 ، أن الأستاذة التي أطردت الطالبة العريانة من قاعة الامتحان ، عادت لتسمح لها بالدّخول بعد أن تطوّع أحدهم بتكفينها بقميص. |